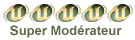حسن بحراوي: مسار السينما المغربية. قراءة في التراكم والأداء
مسار السينما المغربية
قراءة في التراكم والأداء
حسن بحراوي
تستوقفنا في تاريخ السينما المغربية مجموعة من المفارقات والإشكالات الجديرة بالتأمل حقا، وتهم كل من يشغله تتبّع مسار هذا اللون الإبداعي الفتي في بلادنا. وسنسعى في هذه الأوراق إلى الحديث عن أبرز اللحظات التي تناوبت على المشهد السينمائي الوطني مركِّزين خاصة على الأفلام الروائية الطويلة على أمل أن تتاح لنا الفرصة مستقبلا لتناول باقي مكونات هذا المشهد (أفلام قصيرة، وثائقية، إلخ). وستكون الغاية الأساسية هي استنهاض بعض الأسئلة الأولية التي ارتبطت بالممارسة السينمائية خلال العقود الثلاثة الماضية من حيث الأداء الفني والمرجعية الثقافية والفكرية والغايات المتوقعة من ذلك الإنتاج.
ومن جملة ما يذكر بمثابة افتتاح لهذا الحديث، أن المغرب كان من أوائل بلاد الأرض التي شهدت ظهور فن السينما عرْضا وتصويرا؛ وتفصيل ذلك، أنه عندما أطلقت شركة لوميير الفرنسية أول عرض سينمائي لها بباريس في دسمبر 1895، ستقرر القيام بزيارة مجموعة من الأقطار بقصد تصوير وتخليد مشاهد من أواخر القرن الذاهب الذي شهد اكتشاف الفن السابع، وذلك تطبيقا لنيّة أصحابها في جعل السينما أداة تسجيلية ووثائقية ووسيلة للاكتشاف والتأريخ. ومن بين البلاد التي ستستهدفها هذه الجولة مصر وتونس والمغرب الذي سيجري به سنة 1896، أي بعد عام واحد من ميلاد السينما، تصوير أول شريط قصير بعنوان (راعي الماعز المغربي). ونتيجة لهذه الغاية المحدَّدة والظرفية المبكرة سيكون هذا الفيلم ذا طابع إثنوغرافي مفرط التبسيط وشديد التواضع من حيث صناعته الفنية. كما سيجري في السنة الموالية تقديم أول عرض سينمائى في المغرب سيشهده بلاط القصر المخزني بمدينة فاس، تمهيدا للعروض العمومية التي ستتوالى ابتداء من تاريخ فرض الحماية (1912).
وبفضل هذه الواقعة التاريخية المنفلتة تقريبا، كان المغرب سبَّاقا بما لا يقاس إلى استقبال هذا الفن الوافد، إن لم يكن على المستوى الشعبي، فعلى صعيد النخبة المختارة التي يظهر أنها سارعت إلى احتضانه ومدّه بالأسباب الدنيا للوجود. ولكن يبدو أن ما ربحه المغرب في السبق التاريخي قد خسره في الإيقاع المتعثِّر المعاق الذي طبع مسار السينما في المغرب على مدى العقود اللاّحقة.
ومن ذلك أن أول فيلم روائي طويل لن يتم تصويره في المغرب إلا سنة 1919، حيث سيقوم الفرنسيان بنشون وكانتان بإخراج شريط (مكتوب) الذي ستصور مناظره عبر المدن المغربية التقليدية بين طنجة ومراكش، وستكون بؤرة الحكاية التخييلية في هذا العمل البكر هي الطبيعة العذراء ومباهج الحياة الريفية الخالية من المنغّصات، وفي الوقت نفسه تعطي صورة عن»الروح البربرية المتوحشة» التي تسكن أهالي هذه البقاع، بحيث بدا هذا الشريط بمثابة شكل من أشكال تبرير أساليب الحماية وتأبيد السيطرة على البلاد والرغبة الآسرة لدى المستعمر في ترويض سكانها.
وخلال العقود الأربعة التالية من هذا القرن ستزدهر هذه السينما المسماة كولونيالية بسبب كونها تتخذ من المغرب مجرد إطار مشهدي يمرح فيه إنسان شبه بدائي هو الإنسان المغربي تحديدا وديكور تسود فيه النظرة الإثنوغرافية والغرائبية ذات الخيال المجنّح، مما يجعلها تمثل استطالة للأدبيات الاستعمارية الرائجة هنا وهناك في بلاد ما وراء البحار.
وسوف يستمر الوضع على هذا النسق في ترويج صورة البطل الأجنبي المتحضر والمسكون بروح المغامرة بحيث لا ينفك يقهر الطبيعة ويدجن الإنسان ويمجّد المركزية الغربية مبشّرا بتقدّمها الذي لاريب فيه. ولا تُستثنى من ذلك سوى قلة من الأفلام التي أنجزها أصحابها بغير إفراط في الهاجس الإثنوغرافي أوالحسّ الكولونيالي من مثل شريط (كازابلانكا) لمايكل كورتيز (1942)، وشريط (عطيل) لأورسن ويلز (1949) الذي سينال عنه صاحبه السعفة الذهبية بمهرجان «كان» في بداية الخمسينات.
لكن، وابتداء من سنوات الأربعين، سيسجل شاب مغربي من النازحين إلى الدارالبيضاء اسمه محمد عصفور انخراطه في مغامرة غيرمسبوقة لدى مجايليه من أبناء المدن، وهي تصويره، بوسائل شبه بدائية تقريبا، لمجموعة من الأشرطة القصيرة الصامتة التي أنجزها تحت تأثير مشاهداته للسينما الأمريكية مستعملا آلة متهالكة دفع ثمنها على أقساط من القليل الذي كان يربحه من بيعه الجرائد. وستسفر هذه المحاولة عن طراز فريد من السينما الساذجة التي سيسعى فيها صاحبها، بكل الارتباك الممكن تقنيا وفنيا، إلى إعادة إنتاج أوفاق سينما المغامرات الأمريكية من قبيل ماكان رائجا في ذلك الإبان (شابلن، زورو، روبن هود وطرزان...)
وبعد سلسلة من الأفلام القصيرة ذات المستوي المتواضع، التي كان هو نفسه يعرضها على الجمهور في مرأب بالمدينة القديمة مقابل ريالات معدودات، سيتوِّج هذا السينمائي الفطري، رحلته القاسية هاته، بإنجاز فيلمه الطويل الأول (الابن العاق) سنة 1958، حيث سيؤكد فيه تشبُّعه بالمؤثرات التي كانت تمثل الميول والاتجاهات السينمائية التجارية السائدة أيامها (الهوليودية والمصرية وحتى الهندية)، وذلك في غياب وعي نقدي وجمالي قادر على إعانته على الاستلهام الصحيح لمكونات السينما الحديثة، واستيعاب المسافة الحضارية التي قطعتها.
وقد اقتنع محمد عصفور مع مرور الوقت، وخاصة بعد إنتاجه لفيلمه الطويل الثاني (الكنز المرصود) سنة 1970، بأنه لا يتوفر على مؤهلات رجل السينما المعاصر، ربما بسبب أمّيته وفقره، فقرر عن طيب خاطر أن ينسحب من الميدان ويقتصر في عمله على ممارسة مهاراته الحرفية بوضعها رهن إشارة السينمات الأجنبية والوطنية. وهكذا تحرر هذا الفنان العصامي الرائد من طموحه القديم الذي يحبل بالمفارقة: صناعة سينما مهلهلة بأدوات متجاوزة في عصر سينما الملاحم والآلات الرقمية. فأي رهان صعب كان سيجرف الرجل لو تمادى في عناده غير المحسوب العواقب؟
في تساوق مع هذه الجهود الحثيثة الأولى لتخليق سينما مغربية ذات هوية وملامح محلية، وإن بإيهاب استعماري نوعا ما، سيجري تأسيس المركز السينمائي المغربي (1944) الذي سيأخذ على عاتقه إنتاج سلسلة من الأفلام التسجيلية والتربوية والإشهارية، وذلك في أفق يخدم مصالح الحماية الفرنسية في المغرب ويرسّخ حضورها لغة وهوية. وفي هذا النطاق، سينتج المركز مجموعة من الأفلام الطويلة والقصيرة ذات الجودة المتواضعة يهمنا منها ما قام السينمائيون المغاربة الشباب بتوقيعه، من قبيل أول شريط وثائقي وطني معنون ب- (منبع الفن المغاربي) وهو موقع من المخرج أحمد المسناوي سنة 1949، ثم أول شريط تربوي قصير هو (صديقتنا المدرسة) للمخرج العربي بنشقرون سنة 1956. وبعد ذلك ستتوالى تباعا سلاسل الأفلام المغربية القصيرة خاصة في أعقاب حصول المغرب على استقلاله السياسي ( 1956)، وستتكرس أكثر فأكثر ظاهرة الفيلم التسجيلي القائم حول موضوعات الساعة: (عودة الملك محمد الخامس من المنفى، تمجيد الجيش الملكي، بناء طريق الوحدة، محاربة الأمِّية، الإصلاح الزراعي، التجنيد الإجباري إلخ)، والذي كان قد جعل السينما تسد ما يسده الإعلام التلفزي في الوقت الراهن من نشر التعبئة والعمل على التوعية بقضايا معينة. إلخ
إلى جانب ذلك، أسهم المركز السينمائي المغربي في إعطاء الفرصة لشباب السينمائيين لاستكمال تكوينهم وتجريب طاقاتهم، وقد برزت من بينهم كوكبة أولى درست السينما أكاديميا خارج البلاد، خاصة في فرنسا، وتمخضت عن بروز مخرجين متميزين من أمثال محمد التازي وأحمد البوعناني ومحمد عفيفي وحميد بناني ولطيف لحلو ومحمد عبد الرحمن التازي وآخرين. على أنه لأمرٍ ما، فإن هؤلاء جميعهم لن يعطوا ثمارهم إلا مع بداية السبعينات بإقبالهم على خوض مغامرة الأفلام الطويلة والإسهام العملي في تأسيس الانطلاقة الحقيقية للسينما المغربية الناشئة.
وستكون البداية مثقلة بالمصاعب التي عادة ما تصاحب إنتاج الأفلام الأولى، وهذه كانت حالة شريط (الحياة كفاح) سنة 1968 الذي سيسجل الإقلاع الرسمي للسينما المغربية، وهو من إخراج محمد التازي وأحمد المسناوي (1926- 1996). وكان هذان السينمائيان قد قدَّما العديد من الأفلام القصيرة والوثائقية التي لاقت نجاحا متفاوتا، غير أن استعدادهما ومؤهلاتهما لإنجاز فيلم روائي طويل، ظلت أبعد ما يكون عن الاكتمال؛ لذلك ستأتي النتيجة هي هذا الشريط المهلهل شكلا ومضمونا، والذي جاء يحمل فوق ذلك، بصمات الميلودراما المصرية بتركيزه على شخصية المطرب (عبدالوهاب الدكالي)، والبطل الفتوّة (المصارع الحاج فنان)، إلى جانب توابل وطنية أخرى أسييء خلطها (حب، جريمة، تحقيق، إلخ.)، وذلك بالرغم من المجهود البارز المبذول في التصوير (محمد عبدالرحمن التازي)، وكتابة الحوار (المسرحي الراحل عبدالصمد الكنفاوي).
وقد تلت هذا الفيلم، ذا القيمة التاريخية المحدودة، أشرطة أخرى خاملة الذكر، شبيهة به أو أقلّ جودة منه، من قبيل (عندما يثمر النخيل) لعبدالعزيز الرمضاني والعربي بناني، و(شمس الربيع) للطيف لحلو.
وأما شريط «عندما يثمر النخيل»، فيتطرق بأسلوب جديد نوعا ما، إلى موضوع قديم أبدعت فيه السينما الكولونيالية العديد من الأفلام المتدنية المستوى بسبب نظرتها الفوقية ونزعتها الفلكلورية. وهو موضوع الحياة القبلية على تخوم الصحراء وما تزخر به من صراعات بين العشائر المتجاورة للأسباب التافهة التي نعرفها: (نزاعات حول الحدود أو منابع الماء أو أماكن الرعي إلخ). واللمسة النوعية التي أضافها المخرجان في هذه التجربة هي التبشير عند نهاية الفيلم بجيل جديد يحمل روحا بنّاءة وإرادة طيبة يتعالى بها على أسباب التوتر والصراع.
وعلى نفس الوتيرة، يتعرض شريط «شمس الربيع»، الذي أنجز سيناريوهه لطيف لحلو بمساعدة الكاتب المغربي عبد الكريم غلاب، لموضوع جد مألوف في أدبيات المغرب الحديث وهو تصوير لحظة انتقال إنسان البادية بسذاجته ودماثة خلقه للعيش في المدينة الكوسموبوليتية: الدار البيضاء. مع ما يتضمنه ذلك الانتقال من رجّات نفسية وعاطفية تجهز على أحلامه وتبدّد مطامحه مهما تناهت في الصغر، وتدفع به نحو مصير مجهول وغير محسوب العواقب.
وإجمالا، يمكن القول إن أفلام الستينات، فضلا عن قلّتها العددية، لم تسجل أية إضافة متميزة يمكنها أن تمهّد الطريق أمام قاطرة السينما الوطنية التي ظلت لا تكاد تبْرح مكانها متردِّدة بين التقليد وإعادة الإنتاج، وبالتالي غير قادرة على اختراق نقطة البداية.
السينما المغربية في السبعينات
وإلى هنا، يكون قد آن الأوان أن تتحقق الطفرة النوعية التي طال انتظارها من خلال إطلاق التحفة السينمائية الرائدة حقا وهي فيلم (وشمة)، الذي سيخرجه بالأبيض والأسود سنة 1970 حميد بناني مستعينا بزمرة من الفنانين اللاّمعين أمثال المسرحي الراحل محمد تيمود الذي كتب الحوار، والمخرج محمد عبدالرحمن التازي الذي قام بالتصوير، والفنان أحمد البوعناني الذي أنجز المونتاج، بينما شارك في التمثيل محمد الكغاط وعبد القادر مطاع والراحل محمد الأزرق.
ويطرح شريط وشمة، بأسلوب شاعري بسيط، بعض مشكلات المجتمع المغربي التقليدي، خاصة من خلال مظاهر العائلة الأبوية التي تلاقي المتاعب في تربية أطفالها عندما تدفع بهم دون قصد منها إلى مهاوي المغامرة والرعونة. وهو ما حدث للطفل اليتيم مسعود الذي تتبناه أسرة بسيطة الحال لكن ربّها سي المكّي سيذيقه، وهو ينوي تربيته وتهذيبه، ألوانا من القساوة والصرامة تجعل منه شخصا منحرفا قلقا ومحكوما عليه بالموت.
وسيلاقي هذا الفيلم، ولا يزال، الكثير من الإشادة والإطراء، بفضل ارتباطه بلحظة تحققت فيها للسينما المغربية شروط الإبداع الفني والتقني على أوسع نطاق ممكن في ذلك الإبان، وخاصة نتيجة ريادته وتحرره من ظلال السينما المصرية، الشيء الذي سيمكنه من حصد العديد من الجوائز والتنويهات: (جائزة من مهرجان قرطاج، وأخرى من مهرجان دمشق، وجائزة جورج سادول الفرنسية، وتنويهات من فرنسا وألمانيا وغيرها.)
في سياق هذا التحول النوعي الذي طرأ على الممارسة السينمائية الاحترافية، وبدعم متواصل وإن محدود القيمة من المركز السينمائي المغربي، ستتوالى الأفلام المغربية خلال حقبة السبعينات في اتجاهين متعارضين فكرياً وفنياً:
1- اتجاه سينما المؤلّف الجادَّة ذات الأفق الطليعي والبعد السياسي المعلن عنه بهذا القدر أوذاك، وتتفاوت نماذجها بين اتجاهات الواقعية والتعبيرية والعجائبية. ولكنها تلتقي جميعها عند عنصر الانخراط في أسئلة الواقع، كل مخرج من زاوية نظره واعتباره، وبخلفية فكرية وفنية معلنة أو مضمرة تعطي لعمل الواحد منهم نكهته وخصوصيته.
وأبرز ما يمثل هذا الاتجاه، أعمال سهيل بنبركة، خاصة منها فيلم (ألف يد ويد- 1972)، الذي تعرَّض لواقع الاستغلال الذي تعانيه طبقة الحرفيين المشتغلين في قطاع الزرابي وما ينجم عنه من مآسي وخيبات تكتوي بنارها جيلا بعد جيل، وتحديدا تلك «الآلاف من الأيدي» الفتية لبنات في عمر الزهور يكدحن سحابة يومهن لكي تغتني فئة المحتكرين والوسطاء.
ويسجل النقاد أن هذا الفيلم قد حقق خطوة هامة في مسار السينما المغربية على طريق النضوج والاكتمال، سواء من حيث الموضوع أم طريقة المعالجة والأداء الفني. ولذلك لم يكن مستغرباً أن يحصل هذا الإنتاج المغربي الإيطالي المشترك على العديد من الجوائز (جائزتا مهرجاني بيروت وواغادوغو وجائزة جورج سادول).
وشريط (حرب البترول لن تقع- 1975) الذي كما يظهر من عنوانه، يستثمر وقائع الأزمة البترولية لسنة 73 وإجهاض محاولة الدول العربية استعمال سلاح النفط في المعركة. وفيه يقوم تورنر أحد كبار المسؤولين بإدانة الوضع الذي يعيشه بلده من جرّاء احتكار الشركات المتعددة الجنسيات ووقوعه فريسة الفساد الإداري وتهريب الأموال إلى الخارج. الشيء الذي ينجم عنه وضع جد متوتر يهدِّد بالانفجار.
وربما بفضل هذا الموضوع الحساس، نال هذا الشريط جائزة مهرجان موسكو. ولكنه بسبب الحساسية نفسها، ظل في حكم الممنوع من العرض في القاعات المغربية طيلة فترة طويلة.
وقد أنجز بنبركة خلال هذه الحقبة كذلك فيلم (عرس الدم- 1977) المقتبس عن مسرحية لوركا المعروفة. حيث نقل أحداث القصة إلى إحدى قرى الجنوب المغربي التي تعاني من العزلة، وحيث يعيش الفلاح الشاب عميروش الذي تمنعه التقاليد الإقطاعية والظروف الاجتماعية من الزواج بابنة أحد الفلاحين الأثرياء. فيختار الدخول في مواجهة مع الطبقة المتنفذة والتصدي للمشاكل والتحديات التي تفرضها عليه.
وبالرغم من جدية الموضوع وملاءمته للبيئة التي سعى المخرج إلى توطينه فيها، فإن النقاد أخذوا عليه إفراطه في النزعة الفلكورية والإثنوغرافية التي حوّلت بعض أجزاء الشريط إلى ما يشبه الكارت بوسطال السياحية، وبدّدت الكثير من قوته الدرامية وتوتره الإنساني.
وربما كانت مشكلة سهيل بنبركة، الذي درس السينما في إيطاليا وتشبع بأفلام رواد الموجة الجديدة هناك، هي صعوبة وأحيانا استحالة التوفيق بين الرغبة في إبداع سينما ملتزمة اجتماعيا وسياسيا، والحرص على توسيع هامش الاستفادة المادية بالترويج الواسع للمنتوج السينمائي. وهو الرهان الذي لم يتحقق أبدا رغم ما بذله من محاولات، بما فيها الاستعانة في أفلامه بممثلين عالميين كلوران تيرزييف وإيرين باباس وميمسي فارمو، أو التعامل بقفاز من حرير مع القضايا السياسية الشائكة حتى لا يثير غضب السلطة التي لم تتأخر في مكافأته بتعيينه مديرا للمركز السينمائي المغربي وإبقائه على رأسه فترة قياسية غير مسبوقة.
ويضاف إلى أفلام بنبركة الرائدة في هذا الاتجاه العمل البكر لمومن السميحي : (الشري أوالصمت العنيف- 1975)، الذي يطرح بأسلوب رمزي شفاف يلامس حدود المجاز بعض اللحظات المحتقنة من عهد الحماية الفرنسية على المغرب وانعكاسها على الأحوال الشخصية للمواطنين في مجتمع يعاني من مصاعب التحول وإكراهات الحداثة. وذلك عبر حكاية امرأة (عائشة) يقودها سلوك زوجها، الذي صمّم على التزوج بثانية، إلى الخوض في الممارسات السحرية والطقوسية لإثنائه عن تحقيق رغبته. وتنتهي في إحداها إلى الموت غرقا في البحر بطريقة مأساوية.
ومن المفارقات المثيرة أن هذا الفيلم الجميل، الذي كان قد حصد عدة جوائز دولية منها جائزة السينما الشابة بتولون- فرنسا، وجائزة جورج سادول، وجائزة مهرجان قرطاج، قد ظل هو كذلك في حكم الممنوع لعدة عقود لأسباب غير معلومة.
ويمكن أن تُصنف ضمن هذا الاتجاه كذلك، أفلام مصطفى الدرقاوي ذات النكهة التجريبية نوعا ما، مثل فيلم (أحداث بلا دلالة- 1974)، الذي يدشن فيه هذا المخرج الذي درس السينما في بولونيا أسلوبه في المعالجة السينمائية القائمة على مبدأ السينما داخل السينما، حيث تتم مقايسة المتخيل بالواقع في محاولة لفهم ما يجري. ويحكي هذا الشريط قصة سينمائي شاب يكون شاهدا على جريمة قتل وقعت أثناء تصويره لإحدى اللقطات قرب الميناء، الشيء الذي سيشعره بمسؤولية البحث عن الجاني والتحري في دوافع ارتكابه لجريمته. ثم يكون ذلك منطلقا للتأمل في وضعه الخاص كمواطن وكفنان في بيئة لا تقيم وزنا للقيم الإنسانية. وبالتالي مناسبة لبروز الوعي الشقي للمثقف وتساؤله عن دوره في المجتمع.
وبسبب ما طبع هذا الفيلم من ضعف تقني والتباس في القصة والسرد، لم يوفق في إبلاغ فكرته، وسقط في التجريب والغموض. كما أنه لن يسلم بدوره من المنع أو التضييق الذي طاله بحيث لم تتح مشاهدته إلا للقليل من المهتمين.
وفي الفيلم الجماعي (رماد الزريبة- 1976)، الذي اشترك الدرقاوي في إنجازه بمساعدة طائفة من السينمائيين الشباب (الركاب، لقطع، كونجار وسعد الشرايبي...) على سبيل التحدي لواقع سينمائي ملييء بالثغرات، يُطرح موضوع أثير في السينما المغربية المسماة ملتزمة، موضوع الهجرة القروية وما ينجم عنها من تصدع واختلال ينال من الذات الإنسانية للمهاجر جراء التحولات المباغتة التي تفرضها عليه بقوة المدينة الحديثة.
فهذا الشاب القروي عبدالقادر يهاجر إلى الدارالبيضاء أملا في العثور على عمل يساعده على تحسين وضعيته الاجتماعية، لكن الخيبة كانت بانتظاره، وانتهت بأن زرعت في نفسه بذور اللاَّجدوى من التطلع إلى القمة. وعوضا عن تحقيق مطلب الاستقرار الذي كان ينشده، سيجد نفسه على حافة الانحراف بل ومضطرا لاستبدال جلده بآخر يليق بعالم لا يقيم وزنا للمبادىء، فضلا عن إيلاء الاعتبار للمشاعر والعواطف الإنسانية.
ويظهر أن كثرة الأيادي والآراء التي تدخلت عند إنجاز هذا الشريط، قد بلبلت أسلوب المعالجة، ونأت بها عن الاتساق والانسجام المفروض. فجاء هذا العمل عبارة عن مسودة مستعجلة أو خطاطة أولى بدلا من أن يكون بيانا فكريا وجماليا لجماعة السينما الجديدة بالمغرب.
تضاف أيضا إلى هذا الاتجاه الجديد والجاد في مسار السينما الوطنية، الأفلام الأولى لكل من أحمد المعنوني (آليام آليام- 78) الذي فاز بالاعتبار والإشادة، تشهد به الجوائز التي نالها مثل جائزة مهرجان ماينهايم ومهرجان تاورمينا وجائزة مهرجان دمشق. وهو شريط يعزف على نفس الإيقاع السابق ويمضي في تصوير موسم هجرة القرية إلى المدينة والقبول بتكبد الخسارة مهما كانت جسيمة. فعبد الواحد، ذلك الفلاح اليافع، المسكون بالرغبة في الرحيل، تظل تشده إلى عالم قريته جذورعملاقة لا يقوى على اجتثاثها: أمّه حليمة وإخوته الأيتام ورائحة أرضه. ولكن نداء الهجرة يعلو على كل ماعداه، ويحمل البطل على الانسياق وراء الرغبة الآسرة في الذهن والوجدان إلى المغادرة بعيدا عن مسقط الرأس ووصايا الوالدة التي لم يعد بوسعها أن تقنع هذا الطائر المقصوص الجناح بالقعود فريسة البؤس والكدح بدلا من التحليق الحر في الأعالي.
والجديد في هذا الشريط، فضلا عن البساطة في الإنجاز والوضوح في الطرح، هو كونه اعتمد الفلاحين والفلاحات في أداء أدواره، وقد توفق في هذا الاختيار إلى حد بعيد مما طعّم عمله بروح العفوية والأصالة. كما أنه ظل يقف بسبب من طبيعته تلك في منتصف المسافة بين الوثيقة السوسيولوجية والإبداع التخييلي.
وهناك عمل نبيل لحلو البكر (القنفودي- 1978)، الذي استحق أن يحصل به على جائزة لجنة التحكيم وجائزة العمل الأول بمهرجان القاهرة. هذا الفيلم جعل لحلو يدشن تجربته في التعبير عن متخيل جديد جاء هذا الفنان لكي يقاربه مدججا بوعي فني وثقافة أدبية غير معتادة لدى زمرة السينمائيين. فبعد أن لم يعد الفن المسرحي قادرا على استيعاب أحلام وتهويمات هذا المسرحي الطليعي، نقل مجال حلمه إلى الشاشة الكبيرة من خلال قصة جديرة بالخيال العلمي أو حكايات الجدات، فالبطل القنفودي يستيقظ ذات صباح على ثروة هائلة كسبها في يناصيب الفقراء المنظم من طرف السويديين، مما يحدث انقلابا كوبيرنيكيا في حياة هذا الفنان البوهيمي، ويؤجج فانطازماته واستيهاماته إلى الحد الذي يجعله يردد دائما أنشودته المفضلة: آ جرادة مالحة - فين كنتي سارحة - في جنان الصالحة - آش كليتي واش شربتي - غير التفّاح والنفّاح - والقاضي يابومفتاح...إلخ
الشكر موصول للأستاذ بحراوي
مسار السينما المغربية
قراءة في التراكم والأداء
حسن بحراوي
تستوقفنا في تاريخ السينما المغربية مجموعة من المفارقات والإشكالات الجديرة بالتأمل حقا، وتهم كل من يشغله تتبّع مسار هذا اللون الإبداعي الفتي في بلادنا. وسنسعى في هذه الأوراق إلى الحديث عن أبرز اللحظات التي تناوبت على المشهد السينمائي الوطني مركِّزين خاصة على الأفلام الروائية الطويلة على أمل أن تتاح لنا الفرصة مستقبلا لتناول باقي مكونات هذا المشهد (أفلام قصيرة، وثائقية، إلخ). وستكون الغاية الأساسية هي استنهاض بعض الأسئلة الأولية التي ارتبطت بالممارسة السينمائية خلال العقود الثلاثة الماضية من حيث الأداء الفني والمرجعية الثقافية والفكرية والغايات المتوقعة من ذلك الإنتاج.
ومن جملة ما يذكر بمثابة افتتاح لهذا الحديث، أن المغرب كان من أوائل بلاد الأرض التي شهدت ظهور فن السينما عرْضا وتصويرا؛ وتفصيل ذلك، أنه عندما أطلقت شركة لوميير الفرنسية أول عرض سينمائي لها بباريس في دسمبر 1895، ستقرر القيام بزيارة مجموعة من الأقطار بقصد تصوير وتخليد مشاهد من أواخر القرن الذاهب الذي شهد اكتشاف الفن السابع، وذلك تطبيقا لنيّة أصحابها في جعل السينما أداة تسجيلية ووثائقية ووسيلة للاكتشاف والتأريخ. ومن بين البلاد التي ستستهدفها هذه الجولة مصر وتونس والمغرب الذي سيجري به سنة 1896، أي بعد عام واحد من ميلاد السينما، تصوير أول شريط قصير بعنوان (راعي الماعز المغربي). ونتيجة لهذه الغاية المحدَّدة والظرفية المبكرة سيكون هذا الفيلم ذا طابع إثنوغرافي مفرط التبسيط وشديد التواضع من حيث صناعته الفنية. كما سيجري في السنة الموالية تقديم أول عرض سينمائى في المغرب سيشهده بلاط القصر المخزني بمدينة فاس، تمهيدا للعروض العمومية التي ستتوالى ابتداء من تاريخ فرض الحماية (1912).
وبفضل هذه الواقعة التاريخية المنفلتة تقريبا، كان المغرب سبَّاقا بما لا يقاس إلى استقبال هذا الفن الوافد، إن لم يكن على المستوى الشعبي، فعلى صعيد النخبة المختارة التي يظهر أنها سارعت إلى احتضانه ومدّه بالأسباب الدنيا للوجود. ولكن يبدو أن ما ربحه المغرب في السبق التاريخي قد خسره في الإيقاع المتعثِّر المعاق الذي طبع مسار السينما في المغرب على مدى العقود اللاّحقة.
ومن ذلك أن أول فيلم روائي طويل لن يتم تصويره في المغرب إلا سنة 1919، حيث سيقوم الفرنسيان بنشون وكانتان بإخراج شريط (مكتوب) الذي ستصور مناظره عبر المدن المغربية التقليدية بين طنجة ومراكش، وستكون بؤرة الحكاية التخييلية في هذا العمل البكر هي الطبيعة العذراء ومباهج الحياة الريفية الخالية من المنغّصات، وفي الوقت نفسه تعطي صورة عن»الروح البربرية المتوحشة» التي تسكن أهالي هذه البقاع، بحيث بدا هذا الشريط بمثابة شكل من أشكال تبرير أساليب الحماية وتأبيد السيطرة على البلاد والرغبة الآسرة لدى المستعمر في ترويض سكانها.
وخلال العقود الأربعة التالية من هذا القرن ستزدهر هذه السينما المسماة كولونيالية بسبب كونها تتخذ من المغرب مجرد إطار مشهدي يمرح فيه إنسان شبه بدائي هو الإنسان المغربي تحديدا وديكور تسود فيه النظرة الإثنوغرافية والغرائبية ذات الخيال المجنّح، مما يجعلها تمثل استطالة للأدبيات الاستعمارية الرائجة هنا وهناك في بلاد ما وراء البحار.
وسوف يستمر الوضع على هذا النسق في ترويج صورة البطل الأجنبي المتحضر والمسكون بروح المغامرة بحيث لا ينفك يقهر الطبيعة ويدجن الإنسان ويمجّد المركزية الغربية مبشّرا بتقدّمها الذي لاريب فيه. ولا تُستثنى من ذلك سوى قلة من الأفلام التي أنجزها أصحابها بغير إفراط في الهاجس الإثنوغرافي أوالحسّ الكولونيالي من مثل شريط (كازابلانكا) لمايكل كورتيز (1942)، وشريط (عطيل) لأورسن ويلز (1949) الذي سينال عنه صاحبه السعفة الذهبية بمهرجان «كان» في بداية الخمسينات.
لكن، وابتداء من سنوات الأربعين، سيسجل شاب مغربي من النازحين إلى الدارالبيضاء اسمه محمد عصفور انخراطه في مغامرة غيرمسبوقة لدى مجايليه من أبناء المدن، وهي تصويره، بوسائل شبه بدائية تقريبا، لمجموعة من الأشرطة القصيرة الصامتة التي أنجزها تحت تأثير مشاهداته للسينما الأمريكية مستعملا آلة متهالكة دفع ثمنها على أقساط من القليل الذي كان يربحه من بيعه الجرائد. وستسفر هذه المحاولة عن طراز فريد من السينما الساذجة التي سيسعى فيها صاحبها، بكل الارتباك الممكن تقنيا وفنيا، إلى إعادة إنتاج أوفاق سينما المغامرات الأمريكية من قبيل ماكان رائجا في ذلك الإبان (شابلن، زورو، روبن هود وطرزان...)
وبعد سلسلة من الأفلام القصيرة ذات المستوي المتواضع، التي كان هو نفسه يعرضها على الجمهور في مرأب بالمدينة القديمة مقابل ريالات معدودات، سيتوِّج هذا السينمائي الفطري، رحلته القاسية هاته، بإنجاز فيلمه الطويل الأول (الابن العاق) سنة 1958، حيث سيؤكد فيه تشبُّعه بالمؤثرات التي كانت تمثل الميول والاتجاهات السينمائية التجارية السائدة أيامها (الهوليودية والمصرية وحتى الهندية)، وذلك في غياب وعي نقدي وجمالي قادر على إعانته على الاستلهام الصحيح لمكونات السينما الحديثة، واستيعاب المسافة الحضارية التي قطعتها.
وقد اقتنع محمد عصفور مع مرور الوقت، وخاصة بعد إنتاجه لفيلمه الطويل الثاني (الكنز المرصود) سنة 1970، بأنه لا يتوفر على مؤهلات رجل السينما المعاصر، ربما بسبب أمّيته وفقره، فقرر عن طيب خاطر أن ينسحب من الميدان ويقتصر في عمله على ممارسة مهاراته الحرفية بوضعها رهن إشارة السينمات الأجنبية والوطنية. وهكذا تحرر هذا الفنان العصامي الرائد من طموحه القديم الذي يحبل بالمفارقة: صناعة سينما مهلهلة بأدوات متجاوزة في عصر سينما الملاحم والآلات الرقمية. فأي رهان صعب كان سيجرف الرجل لو تمادى في عناده غير المحسوب العواقب؟
في تساوق مع هذه الجهود الحثيثة الأولى لتخليق سينما مغربية ذات هوية وملامح محلية، وإن بإيهاب استعماري نوعا ما، سيجري تأسيس المركز السينمائي المغربي (1944) الذي سيأخذ على عاتقه إنتاج سلسلة من الأفلام التسجيلية والتربوية والإشهارية، وذلك في أفق يخدم مصالح الحماية الفرنسية في المغرب ويرسّخ حضورها لغة وهوية. وفي هذا النطاق، سينتج المركز مجموعة من الأفلام الطويلة والقصيرة ذات الجودة المتواضعة يهمنا منها ما قام السينمائيون المغاربة الشباب بتوقيعه، من قبيل أول شريط وثائقي وطني معنون ب- (منبع الفن المغاربي) وهو موقع من المخرج أحمد المسناوي سنة 1949، ثم أول شريط تربوي قصير هو (صديقتنا المدرسة) للمخرج العربي بنشقرون سنة 1956. وبعد ذلك ستتوالى تباعا سلاسل الأفلام المغربية القصيرة خاصة في أعقاب حصول المغرب على استقلاله السياسي ( 1956)، وستتكرس أكثر فأكثر ظاهرة الفيلم التسجيلي القائم حول موضوعات الساعة: (عودة الملك محمد الخامس من المنفى، تمجيد الجيش الملكي، بناء طريق الوحدة، محاربة الأمِّية، الإصلاح الزراعي، التجنيد الإجباري إلخ)، والذي كان قد جعل السينما تسد ما يسده الإعلام التلفزي في الوقت الراهن من نشر التعبئة والعمل على التوعية بقضايا معينة. إلخ
إلى جانب ذلك، أسهم المركز السينمائي المغربي في إعطاء الفرصة لشباب السينمائيين لاستكمال تكوينهم وتجريب طاقاتهم، وقد برزت من بينهم كوكبة أولى درست السينما أكاديميا خارج البلاد، خاصة في فرنسا، وتمخضت عن بروز مخرجين متميزين من أمثال محمد التازي وأحمد البوعناني ومحمد عفيفي وحميد بناني ولطيف لحلو ومحمد عبد الرحمن التازي وآخرين. على أنه لأمرٍ ما، فإن هؤلاء جميعهم لن يعطوا ثمارهم إلا مع بداية السبعينات بإقبالهم على خوض مغامرة الأفلام الطويلة والإسهام العملي في تأسيس الانطلاقة الحقيقية للسينما المغربية الناشئة.
وستكون البداية مثقلة بالمصاعب التي عادة ما تصاحب إنتاج الأفلام الأولى، وهذه كانت حالة شريط (الحياة كفاح) سنة 1968 الذي سيسجل الإقلاع الرسمي للسينما المغربية، وهو من إخراج محمد التازي وأحمد المسناوي (1926- 1996). وكان هذان السينمائيان قد قدَّما العديد من الأفلام القصيرة والوثائقية التي لاقت نجاحا متفاوتا، غير أن استعدادهما ومؤهلاتهما لإنجاز فيلم روائي طويل، ظلت أبعد ما يكون عن الاكتمال؛ لذلك ستأتي النتيجة هي هذا الشريط المهلهل شكلا ومضمونا، والذي جاء يحمل فوق ذلك، بصمات الميلودراما المصرية بتركيزه على شخصية المطرب (عبدالوهاب الدكالي)، والبطل الفتوّة (المصارع الحاج فنان)، إلى جانب توابل وطنية أخرى أسييء خلطها (حب، جريمة، تحقيق، إلخ.)، وذلك بالرغم من المجهود البارز المبذول في التصوير (محمد عبدالرحمن التازي)، وكتابة الحوار (المسرحي الراحل عبدالصمد الكنفاوي).
وقد تلت هذا الفيلم، ذا القيمة التاريخية المحدودة، أشرطة أخرى خاملة الذكر، شبيهة به أو أقلّ جودة منه، من قبيل (عندما يثمر النخيل) لعبدالعزيز الرمضاني والعربي بناني، و(شمس الربيع) للطيف لحلو.
وأما شريط «عندما يثمر النخيل»، فيتطرق بأسلوب جديد نوعا ما، إلى موضوع قديم أبدعت فيه السينما الكولونيالية العديد من الأفلام المتدنية المستوى بسبب نظرتها الفوقية ونزعتها الفلكلورية. وهو موضوع الحياة القبلية على تخوم الصحراء وما تزخر به من صراعات بين العشائر المتجاورة للأسباب التافهة التي نعرفها: (نزاعات حول الحدود أو منابع الماء أو أماكن الرعي إلخ). واللمسة النوعية التي أضافها المخرجان في هذه التجربة هي التبشير عند نهاية الفيلم بجيل جديد يحمل روحا بنّاءة وإرادة طيبة يتعالى بها على أسباب التوتر والصراع.
وعلى نفس الوتيرة، يتعرض شريط «شمس الربيع»، الذي أنجز سيناريوهه لطيف لحلو بمساعدة الكاتب المغربي عبد الكريم غلاب، لموضوع جد مألوف في أدبيات المغرب الحديث وهو تصوير لحظة انتقال إنسان البادية بسذاجته ودماثة خلقه للعيش في المدينة الكوسموبوليتية: الدار البيضاء. مع ما يتضمنه ذلك الانتقال من رجّات نفسية وعاطفية تجهز على أحلامه وتبدّد مطامحه مهما تناهت في الصغر، وتدفع به نحو مصير مجهول وغير محسوب العواقب.
وإجمالا، يمكن القول إن أفلام الستينات، فضلا عن قلّتها العددية، لم تسجل أية إضافة متميزة يمكنها أن تمهّد الطريق أمام قاطرة السينما الوطنية التي ظلت لا تكاد تبْرح مكانها متردِّدة بين التقليد وإعادة الإنتاج، وبالتالي غير قادرة على اختراق نقطة البداية.
السينما المغربية في السبعينات
وإلى هنا، يكون قد آن الأوان أن تتحقق الطفرة النوعية التي طال انتظارها من خلال إطلاق التحفة السينمائية الرائدة حقا وهي فيلم (وشمة)، الذي سيخرجه بالأبيض والأسود سنة 1970 حميد بناني مستعينا بزمرة من الفنانين اللاّمعين أمثال المسرحي الراحل محمد تيمود الذي كتب الحوار، والمخرج محمد عبدالرحمن التازي الذي قام بالتصوير، والفنان أحمد البوعناني الذي أنجز المونتاج، بينما شارك في التمثيل محمد الكغاط وعبد القادر مطاع والراحل محمد الأزرق.
ويطرح شريط وشمة، بأسلوب شاعري بسيط، بعض مشكلات المجتمع المغربي التقليدي، خاصة من خلال مظاهر العائلة الأبوية التي تلاقي المتاعب في تربية أطفالها عندما تدفع بهم دون قصد منها إلى مهاوي المغامرة والرعونة. وهو ما حدث للطفل اليتيم مسعود الذي تتبناه أسرة بسيطة الحال لكن ربّها سي المكّي سيذيقه، وهو ينوي تربيته وتهذيبه، ألوانا من القساوة والصرامة تجعل منه شخصا منحرفا قلقا ومحكوما عليه بالموت.
وسيلاقي هذا الفيلم، ولا يزال، الكثير من الإشادة والإطراء، بفضل ارتباطه بلحظة تحققت فيها للسينما المغربية شروط الإبداع الفني والتقني على أوسع نطاق ممكن في ذلك الإبان، وخاصة نتيجة ريادته وتحرره من ظلال السينما المصرية، الشيء الذي سيمكنه من حصد العديد من الجوائز والتنويهات: (جائزة من مهرجان قرطاج، وأخرى من مهرجان دمشق، وجائزة جورج سادول الفرنسية، وتنويهات من فرنسا وألمانيا وغيرها.)
في سياق هذا التحول النوعي الذي طرأ على الممارسة السينمائية الاحترافية، وبدعم متواصل وإن محدود القيمة من المركز السينمائي المغربي، ستتوالى الأفلام المغربية خلال حقبة السبعينات في اتجاهين متعارضين فكرياً وفنياً:
1- اتجاه سينما المؤلّف الجادَّة ذات الأفق الطليعي والبعد السياسي المعلن عنه بهذا القدر أوذاك، وتتفاوت نماذجها بين اتجاهات الواقعية والتعبيرية والعجائبية. ولكنها تلتقي جميعها عند عنصر الانخراط في أسئلة الواقع، كل مخرج من زاوية نظره واعتباره، وبخلفية فكرية وفنية معلنة أو مضمرة تعطي لعمل الواحد منهم نكهته وخصوصيته.
وأبرز ما يمثل هذا الاتجاه، أعمال سهيل بنبركة، خاصة منها فيلم (ألف يد ويد- 1972)، الذي تعرَّض لواقع الاستغلال الذي تعانيه طبقة الحرفيين المشتغلين في قطاع الزرابي وما ينجم عنه من مآسي وخيبات تكتوي بنارها جيلا بعد جيل، وتحديدا تلك «الآلاف من الأيدي» الفتية لبنات في عمر الزهور يكدحن سحابة يومهن لكي تغتني فئة المحتكرين والوسطاء.
ويسجل النقاد أن هذا الفيلم قد حقق خطوة هامة في مسار السينما المغربية على طريق النضوج والاكتمال، سواء من حيث الموضوع أم طريقة المعالجة والأداء الفني. ولذلك لم يكن مستغرباً أن يحصل هذا الإنتاج المغربي الإيطالي المشترك على العديد من الجوائز (جائزتا مهرجاني بيروت وواغادوغو وجائزة جورج سادول).
وشريط (حرب البترول لن تقع- 1975) الذي كما يظهر من عنوانه، يستثمر وقائع الأزمة البترولية لسنة 73 وإجهاض محاولة الدول العربية استعمال سلاح النفط في المعركة. وفيه يقوم تورنر أحد كبار المسؤولين بإدانة الوضع الذي يعيشه بلده من جرّاء احتكار الشركات المتعددة الجنسيات ووقوعه فريسة الفساد الإداري وتهريب الأموال إلى الخارج. الشيء الذي ينجم عنه وضع جد متوتر يهدِّد بالانفجار.
وربما بفضل هذا الموضوع الحساس، نال هذا الشريط جائزة مهرجان موسكو. ولكنه بسبب الحساسية نفسها، ظل في حكم الممنوع من العرض في القاعات المغربية طيلة فترة طويلة.
وقد أنجز بنبركة خلال هذه الحقبة كذلك فيلم (عرس الدم- 1977) المقتبس عن مسرحية لوركا المعروفة. حيث نقل أحداث القصة إلى إحدى قرى الجنوب المغربي التي تعاني من العزلة، وحيث يعيش الفلاح الشاب عميروش الذي تمنعه التقاليد الإقطاعية والظروف الاجتماعية من الزواج بابنة أحد الفلاحين الأثرياء. فيختار الدخول في مواجهة مع الطبقة المتنفذة والتصدي للمشاكل والتحديات التي تفرضها عليه.
وبالرغم من جدية الموضوع وملاءمته للبيئة التي سعى المخرج إلى توطينه فيها، فإن النقاد أخذوا عليه إفراطه في النزعة الفلكورية والإثنوغرافية التي حوّلت بعض أجزاء الشريط إلى ما يشبه الكارت بوسطال السياحية، وبدّدت الكثير من قوته الدرامية وتوتره الإنساني.
وربما كانت مشكلة سهيل بنبركة، الذي درس السينما في إيطاليا وتشبع بأفلام رواد الموجة الجديدة هناك، هي صعوبة وأحيانا استحالة التوفيق بين الرغبة في إبداع سينما ملتزمة اجتماعيا وسياسيا، والحرص على توسيع هامش الاستفادة المادية بالترويج الواسع للمنتوج السينمائي. وهو الرهان الذي لم يتحقق أبدا رغم ما بذله من محاولات، بما فيها الاستعانة في أفلامه بممثلين عالميين كلوران تيرزييف وإيرين باباس وميمسي فارمو، أو التعامل بقفاز من حرير مع القضايا السياسية الشائكة حتى لا يثير غضب السلطة التي لم تتأخر في مكافأته بتعيينه مديرا للمركز السينمائي المغربي وإبقائه على رأسه فترة قياسية غير مسبوقة.
ويضاف إلى أفلام بنبركة الرائدة في هذا الاتجاه العمل البكر لمومن السميحي : (الشري أوالصمت العنيف- 1975)، الذي يطرح بأسلوب رمزي شفاف يلامس حدود المجاز بعض اللحظات المحتقنة من عهد الحماية الفرنسية على المغرب وانعكاسها على الأحوال الشخصية للمواطنين في مجتمع يعاني من مصاعب التحول وإكراهات الحداثة. وذلك عبر حكاية امرأة (عائشة) يقودها سلوك زوجها، الذي صمّم على التزوج بثانية، إلى الخوض في الممارسات السحرية والطقوسية لإثنائه عن تحقيق رغبته. وتنتهي في إحداها إلى الموت غرقا في البحر بطريقة مأساوية.
ومن المفارقات المثيرة أن هذا الفيلم الجميل، الذي كان قد حصد عدة جوائز دولية منها جائزة السينما الشابة بتولون- فرنسا، وجائزة جورج سادول، وجائزة مهرجان قرطاج، قد ظل هو كذلك في حكم الممنوع لعدة عقود لأسباب غير معلومة.
ويمكن أن تُصنف ضمن هذا الاتجاه كذلك، أفلام مصطفى الدرقاوي ذات النكهة التجريبية نوعا ما، مثل فيلم (أحداث بلا دلالة- 1974)، الذي يدشن فيه هذا المخرج الذي درس السينما في بولونيا أسلوبه في المعالجة السينمائية القائمة على مبدأ السينما داخل السينما، حيث تتم مقايسة المتخيل بالواقع في محاولة لفهم ما يجري. ويحكي هذا الشريط قصة سينمائي شاب يكون شاهدا على جريمة قتل وقعت أثناء تصويره لإحدى اللقطات قرب الميناء، الشيء الذي سيشعره بمسؤولية البحث عن الجاني والتحري في دوافع ارتكابه لجريمته. ثم يكون ذلك منطلقا للتأمل في وضعه الخاص كمواطن وكفنان في بيئة لا تقيم وزنا للقيم الإنسانية. وبالتالي مناسبة لبروز الوعي الشقي للمثقف وتساؤله عن دوره في المجتمع.
وبسبب ما طبع هذا الفيلم من ضعف تقني والتباس في القصة والسرد، لم يوفق في إبلاغ فكرته، وسقط في التجريب والغموض. كما أنه لن يسلم بدوره من المنع أو التضييق الذي طاله بحيث لم تتح مشاهدته إلا للقليل من المهتمين.
وفي الفيلم الجماعي (رماد الزريبة- 1976)، الذي اشترك الدرقاوي في إنجازه بمساعدة طائفة من السينمائيين الشباب (الركاب، لقطع، كونجار وسعد الشرايبي...) على سبيل التحدي لواقع سينمائي ملييء بالثغرات، يُطرح موضوع أثير في السينما المغربية المسماة ملتزمة، موضوع الهجرة القروية وما ينجم عنها من تصدع واختلال ينال من الذات الإنسانية للمهاجر جراء التحولات المباغتة التي تفرضها عليه بقوة المدينة الحديثة.
فهذا الشاب القروي عبدالقادر يهاجر إلى الدارالبيضاء أملا في العثور على عمل يساعده على تحسين وضعيته الاجتماعية، لكن الخيبة كانت بانتظاره، وانتهت بأن زرعت في نفسه بذور اللاَّجدوى من التطلع إلى القمة. وعوضا عن تحقيق مطلب الاستقرار الذي كان ينشده، سيجد نفسه على حافة الانحراف بل ومضطرا لاستبدال جلده بآخر يليق بعالم لا يقيم وزنا للمبادىء، فضلا عن إيلاء الاعتبار للمشاعر والعواطف الإنسانية.
ويظهر أن كثرة الأيادي والآراء التي تدخلت عند إنجاز هذا الشريط، قد بلبلت أسلوب المعالجة، ونأت بها عن الاتساق والانسجام المفروض. فجاء هذا العمل عبارة عن مسودة مستعجلة أو خطاطة أولى بدلا من أن يكون بيانا فكريا وجماليا لجماعة السينما الجديدة بالمغرب.
تضاف أيضا إلى هذا الاتجاه الجديد والجاد في مسار السينما الوطنية، الأفلام الأولى لكل من أحمد المعنوني (آليام آليام- 78) الذي فاز بالاعتبار والإشادة، تشهد به الجوائز التي نالها مثل جائزة مهرجان ماينهايم ومهرجان تاورمينا وجائزة مهرجان دمشق. وهو شريط يعزف على نفس الإيقاع السابق ويمضي في تصوير موسم هجرة القرية إلى المدينة والقبول بتكبد الخسارة مهما كانت جسيمة. فعبد الواحد، ذلك الفلاح اليافع، المسكون بالرغبة في الرحيل، تظل تشده إلى عالم قريته جذورعملاقة لا يقوى على اجتثاثها: أمّه حليمة وإخوته الأيتام ورائحة أرضه. ولكن نداء الهجرة يعلو على كل ماعداه، ويحمل البطل على الانسياق وراء الرغبة الآسرة في الذهن والوجدان إلى المغادرة بعيدا عن مسقط الرأس ووصايا الوالدة التي لم يعد بوسعها أن تقنع هذا الطائر المقصوص الجناح بالقعود فريسة البؤس والكدح بدلا من التحليق الحر في الأعالي.
والجديد في هذا الشريط، فضلا عن البساطة في الإنجاز والوضوح في الطرح، هو كونه اعتمد الفلاحين والفلاحات في أداء أدواره، وقد توفق في هذا الاختيار إلى حد بعيد مما طعّم عمله بروح العفوية والأصالة. كما أنه ظل يقف بسبب من طبيعته تلك في منتصف المسافة بين الوثيقة السوسيولوجية والإبداع التخييلي.
وهناك عمل نبيل لحلو البكر (القنفودي- 1978)، الذي استحق أن يحصل به على جائزة لجنة التحكيم وجائزة العمل الأول بمهرجان القاهرة. هذا الفيلم جعل لحلو يدشن تجربته في التعبير عن متخيل جديد جاء هذا الفنان لكي يقاربه مدججا بوعي فني وثقافة أدبية غير معتادة لدى زمرة السينمائيين. فبعد أن لم يعد الفن المسرحي قادرا على استيعاب أحلام وتهويمات هذا المسرحي الطليعي، نقل مجال حلمه إلى الشاشة الكبيرة من خلال قصة جديرة بالخيال العلمي أو حكايات الجدات، فالبطل القنفودي يستيقظ ذات صباح على ثروة هائلة كسبها في يناصيب الفقراء المنظم من طرف السويديين، مما يحدث انقلابا كوبيرنيكيا في حياة هذا الفنان البوهيمي، ويؤجج فانطازماته واستيهاماته إلى الحد الذي يجعله يردد دائما أنشودته المفضلة: آ جرادة مالحة - فين كنتي سارحة - في جنان الصالحة - آش كليتي واش شربتي - غير التفّاح والنفّاح - والقاضي يابومفتاح...إلخ
الشكر موصول للأستاذ بحراوي